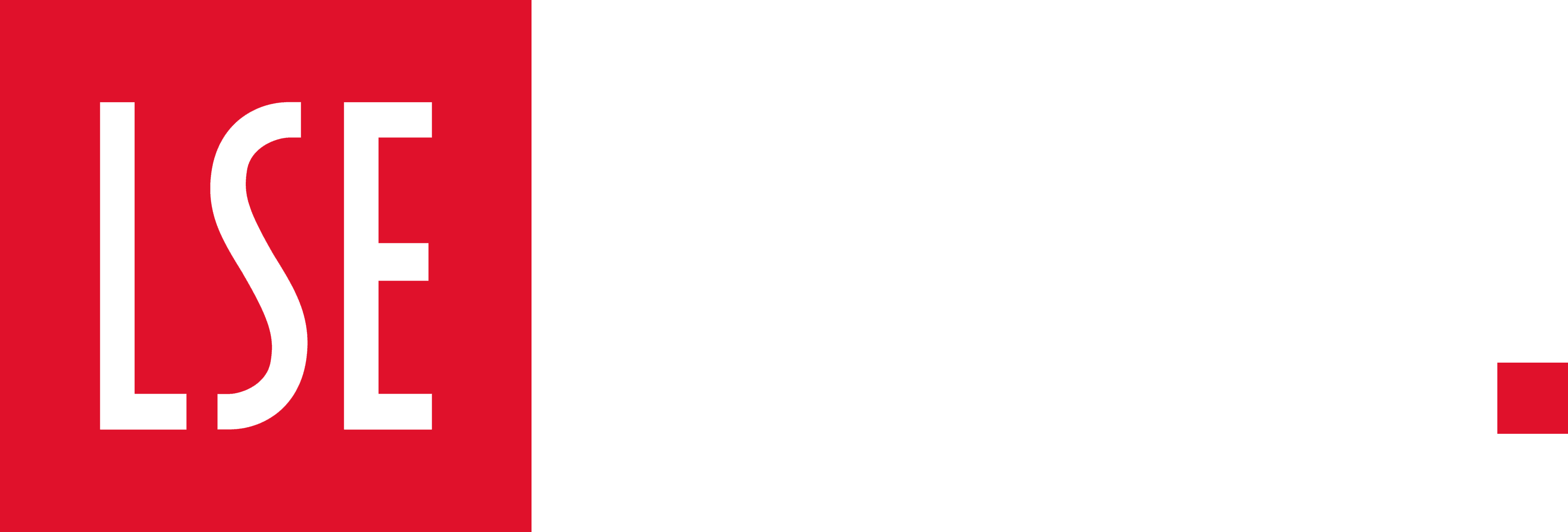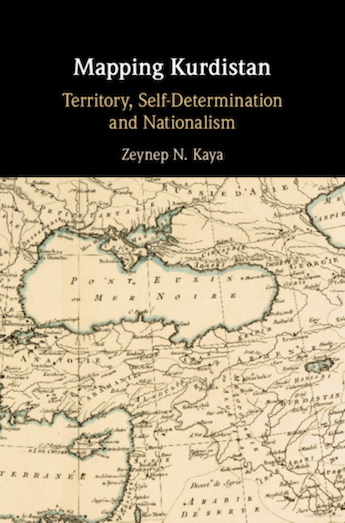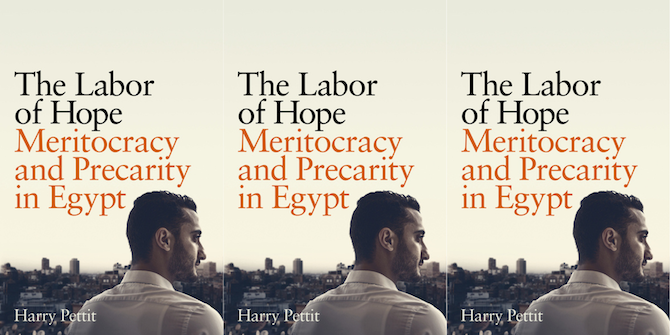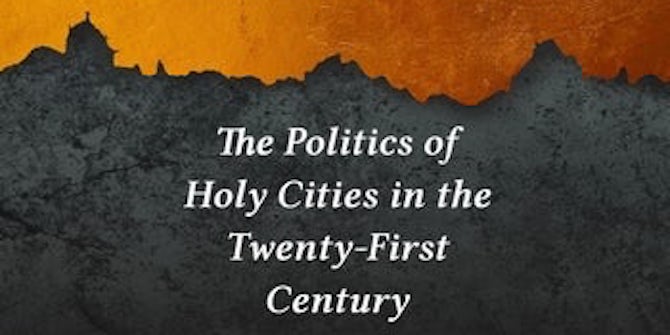بقلم ديفيد ماكدول
في هذا الكتاب المدرك لمصاعب الأكراد في الحصول على اعتراف رسمي على المسرح الدولي ، تلجأ زينب كايا حتماً إلى الطرق التي تم بها ترسيم خريطة كردستان ، كما هو موضح في عنوان الكتاب. من خلال القيام بذلك ، ذكّرتني بمحاضرة في LSE منذ حوالي 15 عاماً أو نحو ذلك ، ألقاها الفيلسوف ، برونو لاتور ، والتي أشار فيها إلى تصنيفين واسعين للحقيقة ، والتي أطلق عليها اسم “سلسة” ، على سبيل المثال الماء هو H²O ، وتلك التي تسمى “خشنة” ، أي تلك المعقدة كالتي تُمنح للمؤهلات أو لِذات الحدود الغير الواضحة. الخرائط ، بامتياز ، تجعل الحقائق “الخشنة” سلسة عن عمد ، وتعرض التعقيد ببساطة مجردة، مع حذف الحقائق التي لا تتناسب مع مخطط رسام الخرائط. هذا ينطبق على الخرائط الحديثة ، مثل هيئة المساحة البريطانية ، كما هو الحال (كما يبدو لنا) بالنسبة للخرائط الإسلامية البدائية . كل هذا يتوقف على ما ترغب أن يفهمه القارئ. تمنى رسامو الخرائط المسلمون الأوائل أن يعرف قرائهم عن المدن والمناطق النائية ، وليس عن -كما في عبارة كارلتون كوون التي لا تنسى – “أراضي الوقاحة” والجبال والصحارى. عندما تم الإشارة الى كردستان في الخرائط لأول مرة في العصر السلجوقي ، كجزء من الجبال المثيرة للقلق.
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، ازداد الاهتمام بالمناطق غير المرسومة في الخرائط ، وخاصة بين المغامرين الأوروبيين. لم يكن لدى العديد من هؤلاء أي هدف غير اكتساب المعرفة ، لكن كان من المحتم أن يكونوا كحصان طروادة للتغلغل الإمبراطوري. فيما يتعلق بكردستان ، كانت الإمبراطوريتان الخارجيتان الأكثر اهتماماً به هما بريطانيا وروسيا ، لكنهما كانتا مهتمتان بشكل أساسي بصفتهما متنافسين راغبين في حرمان الآخر من الفرصة. ومع ذلك ، فقد ساعدت المنافسة بينهما في تسييس الهويات المحلية – الكردية والأرمينية والآشورية – التي كانت بطور سبات سياسياً إلى حد كبير في ظل الإمبراطورية العثمانية. شاركت روسيا وبريطانيا في ترسيم الحدود العثمانية – القاجارية ، وهي عملية استغرقت من عام 1847 إلى 1914 ، وأثارت قلق القبائل الكردية لأنه عندما قطعت الحدود الجديدة طرق انتقالهم ، اضطروا إلى التفكير في الهوية: القبيلة ، والدولة ، والدين. و كما هو متوقع أصبح الجميع مهتمين جداً بالخرائط.
ومع ذلك ، جاءت الأزمة الحقيقية بعد عام 1918 ، مع زوال الإمبراطورية العثمانية. بحلول ذلك الوقت ، كانت كل من القومية التركية والعربية متماسكة ، مدعومة من قبل مفكرين نشطين في مدن مختلفة ومن قبل القوات المسلحة. كان الشعور القومي الكردي لا يزال محصوراً إلى حد كبير في حفنة من الأعيان ، خاصة في اسطنبول ، منقسمين بين أولئك الذين يفضلون الاستقلال العرقي وأولئك الذين يرغبون في الاعتراف الثقافي في إطار عثماني. في فرساي ، أنشأ كردي لا يمثل أي أحد سوى نفسه ، خريطة ، “سلسة” للغاية لدرجة أن حدودها اقترحت بلا خجل الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. في غضون ذلك ، لم يهتم الأكراد ولا الأرمن الناجون بالامعان في حقيقة الواقع في شرق الأناضول حيث تتداخل مطالباتهم المتنافسة بشكل لا ينفصم.
لو كان الأكراد قادرين على تشكيل إجماع وطني ، لكان الكيان المعترف به دولياً ممكناً. حظيت النقطة الثانية عشرة من بيان وودرو ويلسون ، والتي تؤكد حق تقرير المصير لمختلف الشعوب العثمانية ، بالتملق الدولي ، ولكن ليس على موافقة عملية في النهاية. بمجرد انسحاب أمريكا من الشؤون الدولية ، لم يكن لدى بريطانيا ولا فرنسا (روسيا البلشفية بعد أن سحبت الادعاءات القيصرية) أي نية لإخضاع مصالحهم الاستراتيجية لمصالح شعوب المنطقة. (من المسلم به أن الحلم بأية حدود تحترم المجتمعات الدينية أو العرقية كان سيؤدي إلى مشاكلهم المستعصية). أرادت بريطانيا كياناً كردياً شمال بلاد ما بين النهرين ليس من أجل الأكراد ولكن كمنطقة عازلة لصد الأتراك. بمجرد أن ثبت أن هذا غير ممكن ، عززت بريطانيا مشروعها في العراق ، لذلك بدا دمج جنوب كردستان منطقياً من الناحية الاستراتيجية – الدفاع عن سلاسل الجبال أسهل من الدفاع عبر السهل – ديموغرافياً – لأن فيصل الدمية بيدها، أراد المزيد من السنة لتعويض أغلبية الشيعة في العراق. وثالثاً ، لأن جعل تقرير مصير الأكراد بأيديهم من شأنه أن يثير حنق الأتراك. في مثل هذه الظروف جعل تقرير مصير الأكراد بأيديهم لم يُنظر به. لم تكن تركيا ترغب حتى في الاعتراف بوجود أكرادها. بعد ثورة 1925 لم تهتم فرنسا أيضاً بالتنازل عن الحكم الذاتي لأكراد سوريا. (إذا نظرت إلى الأقليات التي نجحت حيث فشل الأكراد ، يتبادر إلى الذهن اثنتان: الموارنة حصلوا على لبنان الكبير الذي اقتطع من سوريا ، حيث كانوا (في البداية) متعجرفين ؛ و اليهود الأوروبيين ذوي رؤوس الأموال الذين انتزعوا فلسطين (اقتطعت من سوريا أيضاً) من شعبها. ولكن في كلتا الحالتين ، كان ذلك ممكناً فقط كجزء من المصلحة الملحوظة لفرنسا وبريطانيا على التوالي).
الفرصة التالية حدثت في تسوية ما بعد الحرب العالمية الثانية. أكد ميثاق الأطلسي لعام 1941 على تقرير المصير كقاعدة جديدة للنظام العالمي. عند تأسيس الأمم المتحدة في مارس\آذار 1945 ، عرضت خويبون قضيتهم ، مصحوبة بخريطة لكردستان ، مقترحة إقليماً يمتد غرباً إلى البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ليشمل ميناء بوشهر الإيراني. ومع ذلك ، وبغض النظر عن مثل هذه الأوهام ، سرعان ما عُلِم أن الأمم المتحدة تفهم تقرير المصير كمبدأ عملي لإنهاء الاستعمار ، وليس لإعادة التفكير في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى. (ربما شعر الأكراد بأنهم مستعمرون من قبل تركيا والعراق وسوريا على التوالي ، لكن الأمم المتحدة لم تسمع مناشداتهم). علاوة على ذلك ، مثلما تستمر حدود الشرق الأوسط في تمثيل الإمبريالية الأنجلو-فرنسية ، كذلك تؤكد الدول الأفريقية الجديدة على وجود استعمار ، الخطوط التعسفية التي رسمها أولئك الذين سارعوا إلى إفريقيا في القرن التاسع عشر.
لقد وجد الأكراد أنه مهما كانت حقوق الأقليات والأفراد و التي أكدتها الأمم المتحدة لاحقاً ، فإنها تظل بلا معنى فعلياً دون دعم خارجي مقنع. ولكن إذا كان هناك شيء واحد تتفق عليه دول المنطقة ، فهو حرمان الأكراد من دولة خاصة بهم. لقد حصلت كردستان العراق وحدها على الاعتراف الدولي ، عندما استغل قادتها ببراعة المصالح الأمريكية لتحقيق حكم ذاتي لم ترحب به الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. لقد كانت ضربة حظ رائعة. أنا أشك بأنها ستتكرر.
على أي حال ، كان الأكراد دائماً منقسمين بشدة فيما يريدون. إن الانقسام الأعمق اليوم ، كما تصف كايا جيدًا ، هو ذلك بين كردستان العراق بحكومته التقليدية القائمة على سيطرة الأقرباء ، والتي لا تزال تتجادل حول الحدود ، وحزب أوجلان العمال الكردستاني “بي-كي-كي” وأشقائه الإقليميين ، الذين تنصلوا من الدول والحدود ، بما في ذلك أي دولة كردية ، في لصالح الديمقراطية المحلية. سيستمر ترسيم خرائط كردستان لجعل التعقيد يبدو بسيطاً ، وللتوجيه والإقناع بالطريقة التي اعتادوا القيام بها دائماً، وسيستمر التأكيد على المبادئ الدولية ولكن القليل منها يعتزم تحقيقها. هذه هي طريقة العالم. لكننا مدينون لزينب كايا لإظهارها ببراعة كيف تكشفت هذه الحقائق القاسية في حالة الأكراد.